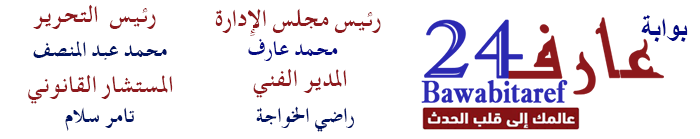كتاب الادب
ايمن صابر السعيد..يكتب..لـ عارف 24..ابن المقفع..حامل لواء النثر الفنى فى الأدب العربي
عبد الله بن المقفّع، واسمه (روزبه) قبل أن يسلم. وُلِد فى قرية بفارس اسمها (جور)- على أرجح الأقوال- سنة 106هـ، لقِّب أبوه بالمقفّع لتشنّج أصابع يديه على إثر تنكيل الحجاج به، بتهمة مدّ يده إلى أموال الدولة، وكان يكنى قبل إسلامه أبا عمرو، فلما أسلم كنى بأبى محمد، وقد أسلم على يد عيسى بن علىّ عم المنصور، ووالى الأهواز؛ إذ كان يعمل كاتبًا لديه.
وقد كان ابن المقفع أديبًا وكاتبًا وشاعرًا فى غاية الفصاحة والبلاغة، وقد سُئل: "مَن أدّبك"؟ فقال: "نفسي، إذا رأيتُ من غيري حسنًا آتيه، وإن رأيت قبيحًا أبَيْته"، وكان يقول: أخذتُ من كل شيء أحسن ما فيه، حتى من الخنزير والكلب والهرّة؛ أخذت من الخنزير حرصه على ما يصلحه، وبكوره فى حوائجه؛ ومن الكلب نصحه لأهله، وحسن محافظته على أوامر صاحبه؛ ومن الهرّة حسن مسألتها، وانتهازها الفرصة فى صيدها".
صفات ابن المقفع:
كان فاضلا ونبيلا وكريما ووفيا، ونستطيع أن نعرف عنه صدقه من خلال كتاباته، ومن الحكايات المشهورة التى تُروى عنه وتدلّ على صدقه ووفائه، أن (عبد الحميد بن يحيى) كاتب الدولة الأموية الشهير، اختبأ فى بيت ابن المقفع، بعد قتل مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية، لكن رجال الدولة العباسية الناشئة توصلوا إليه، ودخلوا عليهما بيت ابن المقفع، وسألوهما: أيكما عبد الحميد بن يحيى؟ فقال كلاهما: "أنا"، خوفا على صاحبه، ولكن العباسيين عرفوا عبد الحميد وأخذوه إلى السفاح.
وقد اشتهر ابن المقفع حتى قبل إسلامه بمتانة أخلاقه؛ فكان وافر المروءة، عاشقًا لحميد الصفات ومكارمها، شغوفًا بالجمال، مؤمنًا بقيمة الصداقة، وإغاثة الملهوف، متعهدًا لذوى الحاجات ومقدرًا للصداقة والصحبة، يحمل نفسه على الأجدر والأنبل، مجتهدًا فى وضع أسس إصلاح الراعى والرعية، متمسكًا بآداب اللياقة ومتطلبات الذوق، قال عنه الجاحظ : "كان جوادًا فارسًا جميلا".
مقتل ابن المقفع:
فى ظل الدولة العباسية اتصل ابن المقفّع بعيسى بن على عم السفاح والمنصور، واستمر يعمل فى خدمته حتى قتله سفيان بن معاوية والى البصرة من قبل المنصور.
وقد اختُلِف فى سبب مقتله، وفى الكيفية التى قُتِل بها، لكن أرجح الأقوال فى سبب مقتله هو أنه بالغ فى صيغة كتاب الأمان الذى وضعه ليوقّع عليه أبو جعفر المنصور، أمانًا لعبد الله ابن على عم المنصور، وكان ابن المقفع قد أفرط فى الاحتياط عند كتابة هذا الميثاق بين الرجلين (عبد الله بن على والمنصور) حتى لا يجد المنصور منفذًا للإخلال بعهده.
ومما جاء فى كتاب الأمان: "متى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله فنساؤه طوالق والمسلمون فى حل من بيعته..."؛ مما أغاظ المنصور فقال: "أما من أحد يكفينيه؟" وكان سفيان بن معاوية يبيّت لابن المقفع الحقد، فطلبه، ولما حضر قيّده وأخذ يقطعه إربا إربا، ويرمى به فى التنور، وكانت آخر كلماته لسفيان بن معاوية: والله إنك لتقتلنى؛ فتقتل بقتلى ألف نفس، ولو قُتِل مائة مثلك لما وفّوا بواحد.
وقد وردت كثير من الروايات فى السبب الذى جعل سفيان بن معاوية يحقد على ابن المقفع، منها: أن ابن المقفع سأله أمام جمع من الناس: ما تقول يا سفيان فى رجل مات وخلف زوجًا وزوجة؟! فالسؤال يحمل إهانة واضحة لسفيان؛ مما جعله يتحين الفرص للنيل منه، حتى سنحت له هذه الفرصة الثمينة، وهى طلب المنصور أحدًا يكفيه شره، وكانت وفاته سنة 142، وقيل: سنة 143، وقيل: سنة 145 للهجرة.
ابن المقفّع بين الحقيقة والتزييف:
يحاول البعض التقليل من شأن ابن المقفّع ورميه، كقولهم إن مذهبه مجوسى من أتباع زرادشت، وإنه لم يسلم إلا للمحافظة على روحه وللتقرب إلى العباسيين، ويتّهمونه كذلك بالزندقة، ولكنّ الحقيقة -فى ضوء مؤلفاته التى بين أيدينا- أنه صاحب نفس شريفة، يقدّر الصداقة حق قدرها، وكذلك الأصدقاء الذين هم عماد الحياة ومرآة النفس؛ لذا نصح بالدقة فى اختيار الأصدقاء.
وإذا كان ابن المقفّع قد أظهر عيوب النُّظُم الإدارية فى عصره، وفضّل النظم الإدارية الفارسية، فإن الحقيقة التى لا جدال فيها أن العرب كانوا بعيدين عن مثل هذه النظم؛ وحين تولى الخلافة الفاروق عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أخذ الكثير من النظم الإدارية عن الفرس التى مكنته من بناء دولة قوية، كان لها أثرها الكبير فى تثبيت أركان الدولة العربية والإسلامية على حد سواء.
آثاره الإبداعية:
خلَّف ابن المقفع آثارًا فكرية عظيمة الفائدة مثلت عصارة فكره وثمرة أدبه، ترجم بعضها من لغاتها الأصلية؛ الفارسية واليونانية والهندية، وأبدع بعضها بقلمه، ومن المؤلفات التى تشهد ببراعته وقدرته فى التوفيق بين الدال والمدلول:
- كليلة ودمنة: وهو مجموعة من الحكايات تدور على ألسنة الحيوانات، يحكيها الفيلسوف (بيدبا) للملك (دبشليم)، ويوضِّح من خلالها ابن المقفع آراءه السياسية فى المنهج القويم للحُكْم، والمشهور أنه ترجم هذه الحكايات عن الفارسية، وأنها هندية الأصل، وإن كانت هناك أبحاث كثيرة تؤكد أن كليلة ودمنة من تأليفه الخاص، وليست مجرد ترجمة، إلا أن هذا هو الشائع ، لكنها لم تكن ترجمة حرفية، وإنما هى ترجمة بلغة فنية عالية، وبروح إسلامية، جعلت أهل عصره، ومن أتى من بعدهم، يقبلون عليها ويتعاملون معها على أنها عربية النشأة، وينسون أصلها. وقد عدها المستعرب الفرنسى دومينيك أورفوا «أحد أعظم كتب التراث العربى وأبقاها».
- الأدب الصغير: عبارة عن كلمات حكيمة فى الأخلاق، لا تسبر أغوار النفس، ولا تغوص فيها، ولا تحلل الخلق تحليلا دقيقًا واسعًا مستوفى، ولكنها عبارة عن جمل موجزة أشبه بالأمثال، أو خطرات تولدت من تجارب صيغت فى عبارات رقيقة رشيقة، وليس ثمة رابط يربط بينها؛ شبهه أحمد أمين برجل يقرأ فى كتب مختلفة، وكلما وجد كلمة أعجبته دوَّنها؛ لذلك ترى كلمة فى محاسبة النفس، وبجانبها كلمة فى الصديق، ثم كلمة فى معاملة الناس بحسب طبقاتهم، ثم فى تعادى الرأى والهوى، لكن الذى يجمع بينها جميعا -كما ذهبنا- أنها تهدف إلى الحديث عن مكارم الأخلاق، وربما يقصد أستاذنا أحمد أمين إلى طريقة التأليف والجمع.
- الأدب الكبير أو الدرة اليتيمة كما يسميه البعض، وهى عبارة عن كلمات مرتبة يدور أغلبها على موضوعين شغلا ابن المقفع طوال حياته؛ أولهما: السلطان والولاة وما يتصل بهما من أمور السياسة والحكم ومعاملة الرعية، وثانيهما: الصداقة وما يتصل بها من صفات الصديق الصالح، حيث قدَّر ابن المقفع الصداقة تقديرًا كبيرًا، ووضعها فى منزلة أسمى من منزلة الزواج الذى هو رابط مقدس. و"يتيمة ابن المقفع" يُضرَب بها المثل لبلاغتها وبراعة منشئها، وهى رسالة فى نهاية الحسن، تشتمل على محاسن من الآداب، وقد ذكر أبو تمام يتيمة ابن المقفع، وأجراها مثلا فى قوله للحسن بن وهب:
ولقد شهدتك والكلام لآلئ تومٌ فبِكْـر فى النظـام وثيِّـبُ
فكأن قسًّا فى عكاظٍ يخطبُ وكأن ليلى الأخيليـة تنــدبُ
وكثير عزة يوم بينٍ ينسبُ وابنُ المقفع فى اليتيمة يسهبُ
-رسالة "الصحابة" وليس يعنى بها صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما هو المشهور فى استعمال الكلمة، وإنما عنى بها صحابة الولاة والخلفاء والأمراء، وهى رسالة عظيمة النفع، جليلة الفائدة، تناول فيها ابن المقفع نظام الحكم ووجوه إصلاحه، متحدثًا فيها عن الأنظمة التى يجب أن تراعى عند النظر إلى (القضاء والخراج والجند)، طارحًا آراءه السياسية الجريئة فى كيفية إدارة الدولة الإسلامية المترامية الأطراف، من خلال إصلاح حال المجتمع ورفع مستوى الجند مع منعهم من تولى الشئون المالية والمدنية، ووضع الأسس الكفيلة بضبط عائدات الخراج، ووضع ما يشبه القانون القضائى حتى لا تترك الأحكام لاجتهادات القضاة الشخصية.
أسلوبــــه:
تميز ابن المقفع بأسلوبه الرشيق السهل؛ فقد كان رأيه أن البلاغة هى التى إذا سمعها الجاهل ظن أنه يحسن مثلها، وكان ينصح باختيار ما سهل من الألفاظ مع تجنب ألفاظ السّفلَة، يقول فى هذا الشأن: "إن خير الأدب ما حصل لك ثمره، وبان عليك أثره"، وكان مع ذلك غزير المعاني، دقيق الألفاظ، يمعن فى اختيار المعنى، ثم يمعن فى اختيار اللفظ، وقد ذكر فى "زهر الآداب" أنهم قالوا: "كان قلم ابن المقفع يقف، فسئل عن ذلك، فقال: إن الكلام يزدحم فى صدرى فيقف قلمى لتخيره، وقال محمد بن سلام فى رسائل البلغاء: "سمعت مشايخنا يقولون: لم يكن للعرب بعد الصحابة أذكى من الخليل بن أحمد ولا أجمع، ولا كان فى العجم أذكى من ابن المقفع ولا أجمع"، وقال جعفر بن يحيى: "عبد الحميد أصل، وسهل بن هارون فرع، وابن المقفع ثمر، وأحمد بن يوسف زهر".
وقد تميز أسلوب ابن المقفع عامة بأنه صوت يعبر عن أغراضه، ويصل العالم الفارسى بالعالم العربى، من خلال دراسة عدد وافر من عباراته؛ حيث تحديد سماته الأسلوبية المثيرة إلى الصياغة الفنية باعتبارها إحدى الخصائص التى يُظهر فيها الأديب مهارته فى نحت الكلمات وتركيب الجمل، وكذلك الملاءمة بين الألفاظ والمعاني، وإن كان يؤثر العناية بالمعنى، مع توخي السهولة فى اللفظ، والبعد عن وحشى الكلام وغريبه، ثم يصب ذلك كله فى قالب "الإيجاز"، وإذا أردنا إيضاح الجانب البلاغى فى لغة أديبنا الحكيم، نستنتج أن أسلوبه امتاز بغلبة السلاسة البلاغية والوضوح، والإيجاز، وبالطريقة العقلانية المنطقية فى الصياغة، والبحث عن الاتساق والانسجام بين الأفكار، وهو لا يستعمل الصيغ البلاغية إلا باعتدال. حيث وُصف أسلوبه بـ "السهل الممتنع"، وكذلك وُصف أيضًا بحسن الصياغة وقوة البيان، وهذا ما جعله يطور النثر حتى عُدّ زعيم الطبقة الأولى من الكتاب دون منازع، وصاحب المدرسة الرائدة فى النثر.